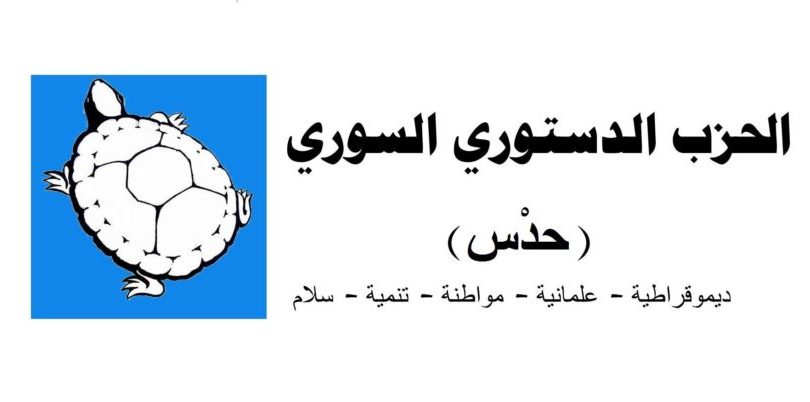الإعلان الدستوري السوري في مرآة الاستبداد… شرعنة الولاية لا بناء الدولة!
مالك الحافظ
تُظهر التجربة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد ملامح تحول معقد لا يتجه بالضرورة نحو التعددية السياسية أو البناء المؤسساتي الديمقراطي، بل نحو نمط سلطوي جديد يتكئ على مرتكزات دينية–أمنية، تجسده السلطة الحاكمة الحالية بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع (الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام). يُمثّل الإعلان الدستوري الصادر عن السلطة الانتقالية الراهنة وثيقة تأسيسية تعكس اتجاهاً سلطوياً مقنّعاً، إذ يمنح الرئيس الانتقالي الحالي سلطات تنفيذية وحتى تشريعية غير مقيدة، ضمن مرحلة انتقالية محددة زمنياً لكنها مفتوحة من حيث الممارسة الفعلية للهيمنة.
ويبتعد هذا النموذج، بنيوياً ووظيفياً، عن المتطلبات الأساسية للانتقال الديمقراطي، مثل التشاركية، المساءلة، فصل السلطات، وضمانات الحقوق السياسية والمدنية، لصالح منطق “الشرعية الثورية المؤطرة دينياً”، الذي يستبطن احتكاراً للسلطة باسم النقاء العقائدي. من زاوية المفهوم السياسي للسلطة، فإن ما تُمارسه القيادة الحالية ليس سلطة انتقالية بالمفهوم الديمقراطي، وإنما إعادة إنتاج لنسق الحكم الشمولي على قاعدة دينية سلفية، تُعيد تفسير العقد الاجتماعي بما يتناسب مع تصورها العقائدي، وهو ما يمكن تحليله من خلال مفهوم “ولاية الأمر الحصرية”، حيث تنحسر مفاهيم المواطنة والتمثيل الشعبي لصالح منطق الطاعة والانضواء ضمن جماعة مؤدلجة. يتجلى هذا المنحى في البنية المؤسساتية المقترحة، حيث تغيب محددات المؤشرات الحقيقية للحوكمة التشاركية،مثل البرلمان الانتقالي، والرقابة القضائية، وهيئات التوازن السلطوي، مقابل بروز كيانات أمنية ودعوية تحوز على الدور الحاسم في توجيه القرار السياسي والإداري، ما يعكس بنية شديدة القرب من نموذج “الدولة التبشيرية” كما صنّفها ماكس فيبر، أي الدولة التي تسعى إلى فرض تصور وحيد للحق والحقيقة، وتُقصي كل الاختلافات بوصفها تهديداً لوحدة الجماعة.
كما يُظهر خطابُ السلطة وتعاطيها مع الإعلان الدستوري، من خلال تشكيل لجنة شرعية تُؤطّره وتُجيزه انطلاقاً من اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن هذا التماهي بين السياسي والديني يندرج ضمن ما يُسمّيه خوان لينز “الأنظمة السلطوية الهجينة”، التي توظّف الرموز الشرعية التقليدية لتأبيد السيطرة على المجال العام، مع الإبقاء على هياكل شكلية تُظهرها في صورة الدولة الحديثة. ويؤدّي هذا الازدواج إلى إفراغ الممارسة السياسية من مضمونها، إذ تصبح مؤسسات الدولة أدوات تمكين لنخبة محددة، بدلاً من أن تكون وسائط تمثيل مجتمعي وتداول ديمقراطي. أما من جهة التكوين الأيديولوجي، فتُظهر السلطة الحاكمة ميلاً لتكريس خطاب استثنائي يقوم على مفاهيم مثل “الطليعة المؤمنة”، و”التمكين”، و”حماية الصفوة”، ما يفضي إلى مأسسة الإقصاء، وتطبيع حالة الطوارئ السياسية والدينية، ويحول دون بناء فضاء عام تعددي. وبهذا المعنى، فإن استخدام الدين كمصدر للشرعية السياسية لا يتمّ عبر قنوات فقهية مؤسسية، بل عبر توظيفه كأداة للضبط الاجتماعي والإقصاء السياسي.
ومن جهة الهيكل السياسي، يُلاحظ أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أية آليات واضحة تضمن تداول السلطة، أو مشاركة قوى الثورة السياسية والمدنية، بل حصرها ضمن الجماعة الحاكمة، ما يشير إلى إعادة إنتاج الدولة السلطوية على قاعدة عقد ولاء شخصي–تنظيمي، يُعيد إلى الأذهان منطق الدولة العميقة، ولكن بأدوات سلفية جهادية هذه المرة، لا بأدوات قومية–عسكرية. ويُضاف إلى ذلك أن ما سُمّي بـ”مؤتمر الحوار الوطني”، الذي كان من المفترض أن يشكّل بوابة تأسيسية لحوار تعددي، جرى تنظيمه على نحو يُفرغه من أي مضمون فعلي. فإلى جانب استبعاده نخباً سياسية وثقافية، فقد انعقد المؤتمر بشكل هزلي ضمن جلسات مضغوطة لم تتجاوز الساعات القليلة، وانتهى بإصدار بيان ختامي غامض وضعيف الصياغة، بدا وكأنه مجرد تمهيد لإعادة إنتاج “البيعة السياسية”، إذ تمّ ربط كل المخرجات – صراحة أو ضمناً – برضا “السلطان” وموافقته. وبهذا، تحوّل المؤتمر من فرصة تأسيسية إلى أداة ترسيخ للهيمنة، تُقوّض أي أفق فعلي لبناء عقد اجتماعي جديد أو دولة جامعة.
تُظهر هذه المؤشرات مخاطر بنيوية تهدد مسار التحول السياسي في سوريا، إذ يتكرّر نمط “التحوّل السلطوي بالشرعية الثورية”، الذي غالباً ما ينتهي إلى إعادة إنتاج منطق الدولة الشمولية تحت مسميات مختلفة. وفي ظل غياب مؤسسات الرقابة وانغلاق المجال العام، لا تُعَدّ السلطة الانتقالية الراهنة امتداداً للمشروع التحرري الذي نادت به الثورة السورية، بل تمثّل انحرافاً عنه، عبر فرض نموذج حكم عقائدي مغلق، لا يستمد شرعيته من التمثيل الشعبي أو العقد الاجتماعي، بل من أيديولوجيا سلفية – قتالية تسعى لإعادة إنتاج منطق الاستبداد تحت غطاء ديني. وبهذا اُختزلت الثورة في جماعة مغلقة، تُقصي المجتمع وتؤمّم السياسة باسم “التمكين”. وعليه، فإن مسؤولية النخب المدنية والمجتمعية تكمن في تفكيك هذا النموذج نظرياً ومؤسساتياً، والدفع نحو إنتاج صيغة حكم ترتكز على التمثيل، والمساءلة، والتشاركية، لا على منطق الغلبة أو الوصاية. فمن دون عقد اجتماعي جديد يُعيد الاعتبار للدولة بوصفها إطاراً مشتركاً لا مِلْكية لجماعة بعينها، سيبقى الاستبداد حاضراً، حتى لو تغيّرت وجوهه وشعاراته.