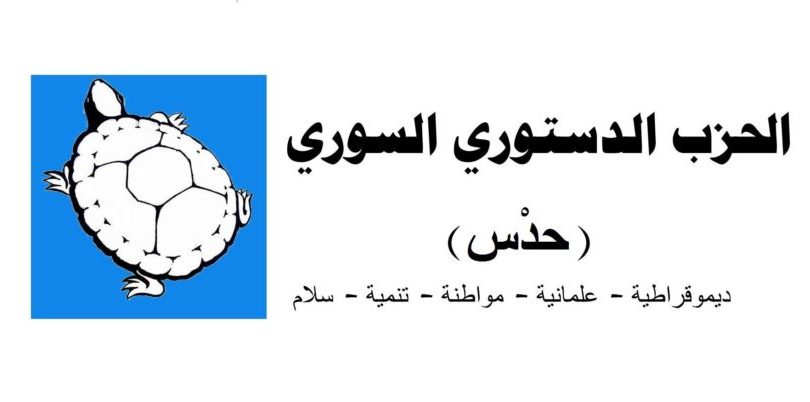الاستحقاق المؤجل.. المقاتلون الأجانب وشرعية السلطة الانتقالية في سوريا
مالك الحافظ
لا يمكن لأي سلطة انتقالية في سوريا أن تدّعي الشرعية السياسية أو تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي، بينما تحتفظ على أراضيها بقوى عسكرية أجنبية تتبع أيديولوجيات ما فوق وطنية. فتجربة المقاتلين غير السوريين، التي نشأت في ظل فوضى السلاح وانهيار الدولة، لم تعد تُقرأ فقط بوصفها عبئاً أمنياً، بل باتت تُنظر إليها كعقبة بنيوية تعيق بناء مشروع وطني سيادي.
لقد أصبح واضحاً أن ملف المقاتلين الأجانب هو أحد أخطر الاستحقاقات المؤجلة في المشهد السوري الجديد. وقد وردت مؤشرات عدة على أن القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لن تنخرط بأي عملية دعم أو اعتراف فعلي بالسلطة الانتقالية طالما ظل هذا الملف من دون حل جذري. لا بل باتت الرسائل السياسية التي تُوجّه لأحمد الشرع – رئيس السلطة الانتقالية – تتضمن إلحاحاً متزايداً على تفكيك هذه البنية، بوصفها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
الاعتماد على المقاتلين الأجانب لحماية بنية الحكم، ليس فقط مؤشراً على ضعف البنية الوطنية، بل هو دليل صريح على غياب الثقة بالمجتمع المحلي. ذلك أن السلطة التي تبحث عن قوتها في خارج النسيج السوري، تُقر ضمنياً بأن حواضنها الداخلية غير كافية لتأمين بقائها. وهذا ما يُذكّرنا بعبارة المفكر الجزائري مالك بن نبي حين قال إن الأمم التي لا تمتلك مشروعها، تستورد أدوات حكمها، حتى لو كانت مفخخة.
وإذا كانت بعض الأنظمة في المنطقة قد استندت إلى “العصبية الطائفية” كوسيلة للتماسك السلطوي، فإن السلطة الانتقالية في سوريا، التي تستند إلى مرجعية سلفية جهادية، تفتقر إلى عصبية داخلية جامعة، ما يدفعها إلى اللجوء إلى مقاتلين أجانب لتعويض هذا النقص، لكن هذا التعويض يحمل في داخله بذور تفككه، لأنه يقوم على رابطة دينية متشددة لا على عقد سياسي جامع.
من هنا، تبرز الحاجة إلى خطة تفكيك معلنة وشفافة لبنية المقاتلين الأجانب، لا كخطوة أمنية فحسب، بل كمؤشر تأسيسي لجدية السلطة في بناء دولة قانون ومواطنة. وقد يكون من المفيد التفكير بتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة أو بدعم من الدول الراعية للعملية الانتقالية، تتولى هذا الملف وتعمل على تسوية أوضاع العناصر غير السوريين، من خلال إعادتهم إلى بلدانهم، أو عبر إخراجهم المنظّم من الفضاء العسكري في مرحلة أولى تأسيسية.
تجارب دولية عديدة يمكن الاستفادة منها في هذا السياق، ففي ليبيا، كان ملف المقاتلين الأجانب محوراً رئيسياً في مسار برلين، وتم ربط أي دعم دولي باستعداد الحكومة المؤقتة للتخلّص من هذه البنية. وفي العراق، لم تنطلق عملية إعادة الإعمار إلا بعد تفكيك بقايا تنظيمات ما فوق وطنية.
إلى جانب ذلك، لا بد من إعادة تعريف مفهوم القوة الشرعية في المرحلة الانتقالية، بحيث لا يكون السلاح بيد مجموعات أيديولوجية خارجة عن العقد الوطني. تأسيس جيش وطني مؤقت، بإشراف مدني، قد يشكّل الخطوة الموازية التي تُغني السلطة عن هذا الاعتماد الخطير.
إن السؤال المركزي الذي يجب أن يُطرح اليوم، هل تسعى السلطة الانتقالية في سوريا إلى ترسيخ شرعية وطنية، أم إلى إدارة بقائها من خلال وكلاء مسلحين غير سوريين؟
الجواب على هذا السؤال سيُحدد مصير السلطة، ويُحدد أيضاً مدى انفتاح المجتمع الدولي عليها. إذ أن الشرعية اليوم، لم تعد فقط تُقاس بالصندوق أو الدستور، بل بمدى تطابق مشروع الحكم مع مفهوم الدولة القابلة للاندماج، لا الدولة المحاصرة. والمجتمع الدولي، وإن تواطأ أحياناً، إلا أنه لا يمنح اعترافاً دائماً لكيانات تمثّل نسخاً باهتة من “الإمارات المؤدلجة”.
إن التخلص من المقاتلين الأجانب ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة سيادية. فإما أن تبدأ السلطة الانتقالية من هذا الباب في تشكيل علاقتها مع السوريين ومع العالم، وإما أن تبقى حبيسة جغرافيا متوتّرة، تحكمها بنية فوق وطنية، وتُدار على إيقاع العقوبات والضربات الجوية لعقد آخر من الزمن.