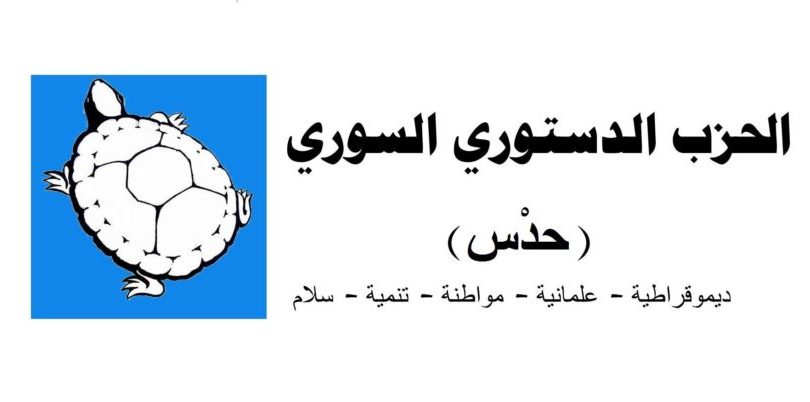البراغماتية بين المنهج والفهم المغلوط… تفكيك دعوى “الاعتدال النفعي” في الحالة السورية
مالك الحافظ
في زوايا الفكر السياسي المعاصر، تبرز البراغماتية كواحدة من أكثر المفاهيم التباساً، بل وأكثرها تعرضاً للتوظيف العشوائي والخلط المقصود. فهي عند كثيرين مجرد أداة للتملّص من المبدأ، أو حيلة لتبرير التقلب في المواقف. لكنها في أصلها الفلسفي ومنهجها السياسي العميق، أبعد من أن تكون خطاباً للمواءمة أو وسيلة للانتهازية المقنّعة.ولعلّ ما يعيدنا إلى هذه النقطة اليوم هو التوصيف المتكرر لرئيس السلطة الانتقالية السورية الحالية، أحمد الشرع، بأنه يتبنّى مساراً براغماتياً عقلانياً، يتخلى عن التشدّد ويعيد تموضع السلطة ضمن ما يُوصف بـ”موقع الاعتدال”. وهو توصيف لا يصمد طويلاً أمام الفحص النقدي، لأنه يقوم على تزييف المفهوم، لا على تجسيده.
من حيث الأصل، البراغماتية ليست نزعة مزاجية، ولا حيلة تكتيكية. إنها فلسفة فكرية نشأت في الفكر الأمريكي نهاية القرن التاسع عشر، على يد مفكرين هما تشارلز بيرس، وويليام جيمس، ثم تطورت لاحقاً مع جون ديوي، لتأخذ طابعاً سياسياً وأخلاقياً ومعرفياً. جوهر البراغماتية هو الربط بين الفعل ونتيجته، بين الفكرة وقيمتها العملية، في ضوء ما تحققه من أثر واقعي.
لكن هذا المنهج، وإن كان عملياً، لا يعني التخلّي عن المبادئ، بل إعادة صياغتها في ضوء المتغيرات، من دون أن تُمس القيم الكبرى أو تشوّه الأطر الأخلاقية. البراغماتي الحقيقي ليس ذلك الذي يُغيّر رأيه بحسب مصلحته، بل هو الذي يُكيّف أدواته بما يخدم هدفاً أعلى ثابتاً، مرتبطاً بالمصلحة العامة لا بالمكسب الشخصي.
الشخص البراغماتي، كما وصفه جون ديوي، هو من “يدير الواقع لا ليهرب من القيم، بل ليُنجزها”. ولذلك فإن البراغماتية ليست انزلاقاً نحو النفعية الرخيصة، بل موازنة بين الإمكانيات والمبادئ، بين المرونة والانتماء، بين النتائج والسياق.
البراغماتي الحقيقي صاحب مشروع، لا مجرد “رجل مرحلة”. لا يكيّف خطابه فقط ليستمر، بل يُكيّف الوقائع ليبني نموذجاً جديداً للاستمرار بكرامةٍ وقيمة.
وبالتالي، فإن الشخصية البراغماتية من الطراز الرفيع لا تقفز من موقف إلى آخر كمن يتنقل بين ضفاف النهر، بل تتحرك بثبات عبر الجسر الذي تبنيه على كل ما تتجاوزه.
في الحالة السورية، تحديداً مع السلطة الانتقالية التي يقودها السيد أحمد الشرع، نشهد تكراراً لادعاء البراغماتية، في الوقت الذي تُمارس فيه سياسات مشحونة بالتكتيك المصلحي الضيق، والمواقف المتقلّبة، والتبريرات الانتهازية، من دون وجود مشروع وطني متماسك، أو رؤية سياسية تؤمن بفكرة الدولة والإنسان.
والأخطر من ذلك، هو الخلط المتعمد بين البراغماتية والاعتدال. إذ يروّج الخطاب السياسي الحالي أن التدرج في المواقف العقائدية، والتخفيف من اللهجة السلفية الجهادية، هو “تحول براغماتي”. لكن ما يغيب عن هذا الخطاب أن البراغماتية لا تعني التجميل المؤقت للمشروع، بل التحوّل الجوهري فيه.
إن السياسات القائمة على تقاسم النفوذ، وتكريس الهيمنة العقائدية تحت لافتات مؤسساتية، ليست نتاجاً لبراغماتية مدروسة، بل لبراغماتية زائفة، تُقارب مفهوم “النفعيّة” كما انتقدها ماكس فيبر في حديثه عن “أخلاق المسؤولية” مقابل “أخلاق الاقتناع”.
في نهاية المطاف، لا تُقاس البراغماتية بالأقوال، بل بالنتائج، فحين تكون النتيجة دولة مُجهضة، ومجتمع خائف، وبنية سلطوية تقوم على الانضباط العقائدي لا التمثيل المدني، فنحن لا نتحدث عن مشروع براغماتي، بل عن سلطة تتهرّب من التصنيف الحقيقي، أنها سلطة مأزومة تكتفي بترقيع صورتها.
كما أن التغيّرات الحادة في المواقف العقائدية، أو في التحالفات السياسية، أو حتى في الخطاب الإعلامي، لا تنبع من قراءة براغماتية متأنية للواقع، بل من اضطرار تكتيكي تفرضه ضغوط داخلية وخارجية، وهو ما يجعل هذه التحولات فاقدة للتماسك، ومكشوفة في هشاشتها.
إن البراغماتية الحقيقية، كما تُدرّس في الفكر السياسي، لا تُستعار من اللحظة، بل تُبنى عبر الوعي بها كمنهج.
أما ما نراه اليوم في سوريا، فهو أشبه بـنفعية مقنّعة، تستبدل العنف بالضبط، والسلاح بالخطاب، دون أن تعيد النظر في المنطلقات العميقة التي أفرزت واقعها.
البراغماتية ليست قناعاً يُرتدى عند الحاجة، بل هي ضميرٌ عمليّ، لا يستقيم إلا إذا اقترن بالمبدأ، وتحرّر من الخوف، وعرف إلى أين يمضي.