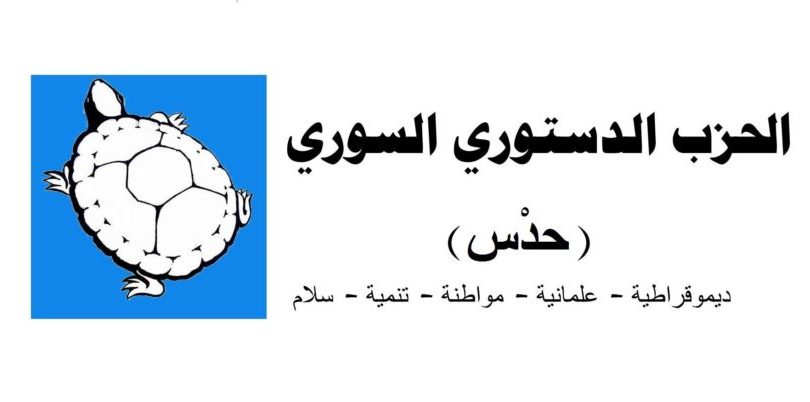سلطة الشرع الهجينة أو اللانظام
حسام ميرو
منذ وصول “هيئة تحرير الشام” إلى السلطة في دمشق، يحاول قلّة قليلة من المثقفين السوريين تقديم مقاربتهم لهذه السلطة، ليس فقط بغرض تشريحها معرفياً، وإنما إيضاً، وهذا ما يتضح من كتاباتهم، إقامة وعي بمخاطرها على سوريا، أي أنهم يأخذون دور المحلّل/ المنظّر، ودور السياسي/ التغييري في الوقت نفسه.
الإشارة إلى أن من يقومون بهذا الدور هم قلّة قليلة تبدو أساسية، لا بوصفها إشارة إشادة فقط بدورهم، وإنما لكشف ما يعتري الواقع السوري من نقص في الفكر النقدي، وفي إنتاج هذا الفكر، لكن أيضاً من الضرورة بمكان الإشارة أيضاً إلى أنهم يتابعون بشكل أو بآخر سياقاً فكرياً نقدياً سورياً شارك فيه أيضاً قلة قليلة من المفكرين والمثقفين السوريين منذ ستينات القرن الماضي، تناولوا بقراءات منهجية، ومرجعيات نظرية مختلفة، موضوعة السلطة.
فيما توفّر لي الاطلاع عليه منذ أن تولّت السلطة الجديدة الحكم، سأقدّم بعض الملاحظات على الكتابات النقدية، خصوصاً بما يرتبط بالمناهج المتبعة من قبل هذه القلّة القليلة، وهذه الملاحظات هي ملاحظات أولية، لا أزعم أنها تستوفي تغطية كل المستند المرجعي النظري في الكتابات النقدية الحالية، كما أنه من المفيد التأكيد هنا إلى أن هذه الملاحظات لا تعني أنها موجودة بالقدر ذاته عند من يحلّلون طبيعة السلطة الحالية.
1- هناك مقاربة وصفية تاريخية للسلطة الحالية، من خلال العودة إلى سياق السلطة تاريخياً منذ تشكّل الدولة السورية في عام 1920.
2-هناك مقاربة تنطلق من نموذج السلطة التاريخي في المنطقة، أي نموذج الحكم السلطاني في السلطنة العثمانية.
3- هناك مقاربة تنطلق من علاقة السلطة بالواقع، أي من مساءلة قدرة السلطة، مطلق سلطة، على تأمين حدود معقولة من المهام والتحدّيات، الأمنية، والخدمية، والاقتصادية، والمعيشية.
4- هناك مقاربة تنطلق من فكرة الشرعية، أي حاجة السلطة، مطلق سلطة، لتأمين مطلب الشرعيتين الخارجية والداخلية.
5- هناك مقاربة بنيوية، تقوم بقراءة علاقات القوّة داخل بنية مكونات السلطة الجديدة، وطبيعة المشكلات البنيوية الموجودة لديها، ومدى قدرتها على التحوّل من بنية فصائلية إلى بنية سلطة عامّة.
6- هناك مقاربة بنيوية أخرى، أكثر خصوصية، تقوم بقراءة البنية الأيديولوجية للسلطة الحاكمة (السلفية) ومدى مرونتها وقدرتها على إقامة علاقات مع قوى دينية أخرى من داخل المجتمع الإسلامي نفسه، وتحديداً مع الأشعرية الشامية، أو علاقتها مع الفئات الدينية والمذهبية الموجودة تاريخياً في المجتمع السوري.
إلى ماذا يشير تعدّد المقاربات موضوعياً؟
1- وجود حاجة موضوعية، ليس فقط لتأطير فهم نظري طبيعة السلطة الحالية، وإنما لتحليل سلوكها العملي منذ وصولها إلى سدّة الحكم، ومحاولة توقّع نمط سلوكها المستقبلي.
2- أن انهيار نظام بشار الأسد، الذي خضع خلال حكمه، وتحديداً بعد عام 2011، إلى تحليل متعدّد، ترك البلاد في حالة من اللانظام، بعد اختفاء كبار ضباط الجيش والأمن، وقيام السلطة الجديدة بحلّ المؤسستين العسكرية والأمنية، واستدعاء حكومتها (الإنقاذ) من إدلب إلى دمشق.
3-أن القوى السياسية المعارضة لنظام الأسد، والتي يمكن فرزها إلى ثلاثة أقسام، الإسلامية (أصبحت في موقع قريب من السلطة)، والوطنية (هذه تحاول التموضع إلى جانب السلطة)، والديمقراطية (وهذه معظمها في حالة ترقّب أو البحث عن تموضع قريب من السلطة)، ولكل واحدة من بين هذه الأقسام رؤية خاّصة بها، وهذه القوى لم تقدّم حتى الآن رؤية نقدية للسلطة، لأن تقديمها أي رؤية نقدية، سيموضعها تلقائياً في خانة القوى المعارضة للسلطة الج، وقد قرأنا مؤخرا بيان أحد التحالفات، الذي يقول مؤسسوه إنهم “لا موالاة ولا معارضة”، وهو أمر لم يعرف له (ربما) مثيل في تاريخ الحركات السياسية بحسب علمي.
4- ربما الأهم في تعدّد المقاربات الموجودة هو أمرين: الأول هو غياب النقد الصادر عن معظم القوى السياسية، وربما كان الحزب الدستوري السوري (حدّس) الأكثر مواظبة عبر بياناته أو كتابات أعضائه، في تقديم تحليل نقدي للسلطة الحالية. الأمر الثاني هو أن السلطة الحالية تفصح في مجمل خطابها وسلوكها وقراراتها عن سلطة هجينة، لا يمكن مقاربتها من زاوية نظرية محدّدة.
في السلطة الهجينة أو اللانظام
إن مجموع المقاربات النقدية للسلطة الجديدة، تحاول أن تمسك بمحدد أو معيار للسلطة الحالية، يمكن من خلاله تحليل سلوك السلطة، والنظام السياسي الذي تقوم على تأسيسه، إذ أن كلّ نظام سياسي له مجموعة معايير وقواعد، لكن على الرغم من ذلك يوجد معيار ما، يبقى الأساس في توصيف النظام، وعادة يمتلك هذا المعيار معايير عدة هي من صلبه، ففي توصيف الأنظمة الغربية اليوم، يبقى المعيار الأساس هو الليبرالية، متضمناً بطبيعة الحال التعددية السياسية والديمقراطية وضمان حرية المعتقدات للمجموعات والأفراد، وحرية عمل النقابات، وفي المؤسسات هناك فصل للسلطات، وغير ذلك، مما تشتمل عليه الليبراالية، مع وجود فوارق بدرجة التطبيق بين نظام وآخر.
في الأنظمة الاستبدادية، عسكرية أو مدنية أو دينية هناك سلطة شبه مطلقة للحاكم، لكن حتى هذه الأنظمة، هناك فوارق كبيرة بينها بالدرجة، إذ لا يمكن مقارنة نظام مثل كوريا الشمالية بنظام روسيا الاتحادية، حيث يتمتع حاكما البلدين بصلاحيات شبه مطلقة، عدا عن الاستمرار في الحكم، كما لا يمكن مقارنة اقتصاد الأولى ونمط الحريات فيها بالثانية.
في الأنظمة السلطانية، تقوم السلطة على أساس النمط الوراثي للحكم مع صلاحيات مطلقة للسلطان، الذي يحظى أيضاً بمباركة المرجعيات الدينية، ويمكن أن يكون هو ذاته المسؤول الديني الأول: الأمير.
السلطة الجديدة في سوريا، لا يمكن توصيفها بشكل حتمي ضمن النظامين الاستبدادي أو السلطاني بالمعنى المتعارف عليه لهذين النظامين، كما لا يمكن القول إنها لا تنتمي لهما، فالصلاحيات التي حاز عليها أحمد الشرع عبر الإعلان الدستوري هي صلاحيات مطلقة، كتلك الموجودة في النظامين السلطاني والاستبدادي، لكن في الواقع، لا يتمتع نظام الشرع (تجاوزاً تسمية نظام) بما يتمتع به النظامان السلطاني والاستبدادي، خصوصاً لجهة احتكار العنف إلا من الناحية الإسمية كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة، في الوقت الذي تتموّل فيه بعض الفصائل الأساسية من خزينة دولة خارجية هي تركيا، وليس في خزينة الشرع ما يجعله مركز السلطة السلطة السلطانية أو الاستبدادية.
يسعى الشرغ كما هو ظاهر عملياً إلى نسج علاقات مع القوى النافذة في الجغرافيا السورية، ليس انطلاقاً من وجود رؤية سياسية محدّدة، وإنما انطلاقاً من الأمر الواقع الذي تحوز فيه الواقع على شرعية، تختلف عن الأخرى.
على المستوى الاقتصادي، لا خطة عملياً لدى الشرع للاقتصاد، فكلّ ما يوجد هو كلام عمومي حول تطوير البلد، وتحويلها إلى دولة متقدّمة مثل سنغافورة، في الوقت الذي تغيب فيه أبسط الخدمات العمومية، وليس واضحاً بعد إذا كان الشرع أو حكومته سيعلنون عن ميزانية عامة للحكومة.
على مستوى العلاقات الخارجية، فإن الأنظمة السياسية، تحدّد تموضعها في هذه العلاقات، فتأخذ مواقف معينة معلنة من القوى الخارجية، وهذا الأمر لا يقوم به الشرع، فهو يعلم أنه لا يستطيع، فهو يسعى للتوفيق بين مصالح الدول، لضمان دعمها، أو على الأقل لضمان عدم عرقلة استمراره في الحكم، لكن هو بذلك يحاول التوفيق بين متناقضات لا يمكن التوفيق فيما بينها.
إن أقل ما يمكن قوله لغاية الآن، إن مجمل المقاربات النقدية والمهمة لسلطة الشرع، تشير بوضوح إلى نمط من السلطة الهجينة أو اللانظام.