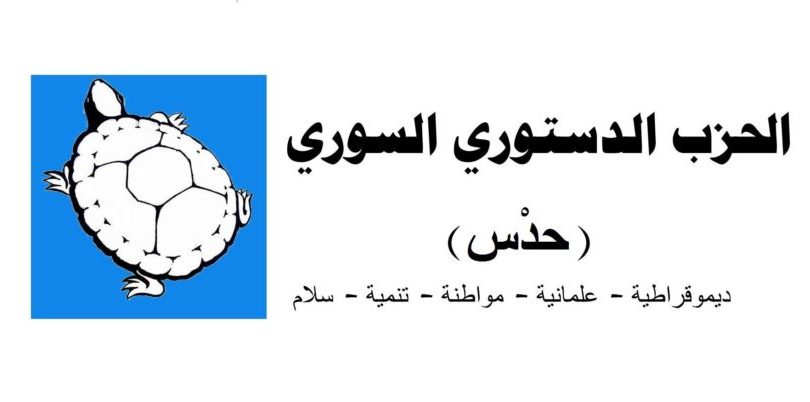العلمانوفوبيا ميل “إسلامي” جماهيري أم ضرورة للسلطة الحاكمة في سوريا؟
حسام ميرو
قبل عام 2011، كان النقاش حول العلمانية في سوريا محصوراً بدائرة صغيرة من الأساتذة الأكاديميين أو بعض المثقفين، ولم تكن العلمانية أولوية في أي من أحزاب المعارضة السياسية، أو حتى أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وربما الحزب الوحيد الذي تعامل مع العلمانية كأولوية، كان الحزب القومي السوري الاجتماعي.
بعد الانتفاضة السورية، التي تداخلت فيها صراعات عديدة، جرت شيطنة مفهوم العلمانية، في إطار تبرير القوى الإسلامية المسلحة وغير المسلحة لإخفاقاتها، خصوصاً بعد سقوط مدينة حلب في عام 2016، حيث طرح سؤال : ماذا قدّم العلمانيون للثورة؟.
في السنوات الماضية، غادر مفهوم العلمانية إطار التداول النخبوي، ليتحوّل إلى سجال عامّي، بكل ما تحمله حالة السجال العامّي من إيجابيات وسلبيات، فدخول مفهوم العلمانية الحيّز العام مؤشر على أمور عديدة، من بينها أن طبيعة الدولة المنشودة في البلاد أصبحت في صلب الخلافات الكثيرة بين السوريين، التي تمسّ مستقبل حياتهم، وهي خلافات متوقعة أو ينبغي أن تكون متوقعة، بعد حوالي 14 عاماً من صراعات عديدة عاشها السوريون.
النقاش اليوم حول العلمانية يأخذ منحنى أكثر حدّة، لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها أن النقاش لا تقوده وتتجادل فيه وحوله قوى وشخصيات ذات تأثير، ومعترف بكونها مرجعية ولها تمثيل وحيثية، ما يمنحها القدرة على ضبط جوانب النقاش والخلافات الأكيدة والمحتملة، من دون أن تكون الخلافات سبباً في توتير الأجواء الاجتماعية وتصعيدها طائفياً، بل أن النقاش العامّي (العمومي) الحاصل اليوم يتّسم بجهل كبير بتاريخية المفهوم، والعلاقات القانونية التي يؤسس لها، ودوره التاريخي في تطوير العقلانية، من خلال جدل تبادلي بين العقلانية والعلمانية، حيث أن الأولى مؤسسة بالضرورة للثانية.
لفظ “علمانية” في اللاتينية مقترن بألفاظ الزمن، والقرن، والعهد، وهو تأكيد على الزمن الدنيوي، أي زمن التاريخ، بوصفه منتجاً بشرياً، منتجاً يصنعه البشر في خضم صراعاتهم وأحلامهم وطموحاتهم، في مقابل الزمن الميتافيزيقي المتعالي، وهذه التقابلية الضرورية، من مهامها إيجاد الخطّ الحدودي الفاصل بين زمن الواقع وزمن الميتافيزيقيا، أو ما وراء الواقع والطبيعة.
بعد حرب الثلاثين عاماً الدينية في أوروبا ( 1618 و1648)، أخذ مفهوم الدولة يرتبط أكثر بالعلمانية، فقد أسست معاهدة ويستفاليا عام 1648 التي أنهت الحروب الدينية وفق مبدأ سيادة الدول على أراضيها، وهو المبدأ المؤسس لاحقاً للأمم المتحدة، كما أسهمت معاهدة ويستفاليا في تحويل الدولة نحو العلمنة.
سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تعاني من انقسامات حول قضايا عديدة، في صلب هذه الانقسامات هناك سؤال الدولة، بصيغ متعددة: هل الأفضل لسوريا أن تكون دولة بلا مرجعية دينية، وهل مظاهر التدين أمر خاص وفردي، أم أن الحفاظ على الدين والتدين من مهام الدولة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو حال التنوع الديني والمذهبي وفئة اللادينيين، وكيف ستكون مناهج التعليم، وهل الأفضل لسوريا أن تكون دولة لا مركزية أم تبقى مركزية، هل ستكون هناك تعددية سياسية وانتخابات وبرلمان مستقل,,,,,,إلخ.
هذه الأسئلة أسئلة حقيقة، بل هي الأسئلة الحقيقية اليوم، لكن طرحها والسجال حولها يحدث في إطار عام منقسم، وفي إطار وصول سلطة ذات خلفية دينية سلفية للحكم، وفي إطار محاولة استثمار سياسي في العصبيات الطائفية، خصوصاً لجهة الفئة الحاكمة، التي تقوم بالهروب إلى الأمام، والقفز من فوق الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الدفع بحالة استقطاب في مشاعر فئات كثيرة، عاشت لسنوات حالات قهرية من قبل نظام بشار الأسد، من قتل وسجن وتهجير ولجوء، ومحاولة إظهار وصولها للحكم على أنه انتصار للأكثرية على الأقلية، وأن نجاح الدولة بالتالي مرهون بالالتفاف حول الحكم لمنع عودة حكم الأقلية، وفي إطار ممارسات الحكم الحالي لزيادة شرعيته من “الأكثرية”، يبالغ في إظهار ممارسات دينية، تعكس منطق الغلبة لديه، وفي الوقت نفسه، تقوم فصائل موالية له بارتكاب جرائم ضد العلويين بشكل خاص في الساحل السوري، وإظهارها على أنها أتت في سياق انفلات أمني، حدث خلال مواجهة الجيش لما بات يعرف ب”فلول النظام”.
في هذا المناخ العام، تظهر حالة العلمانوفوبيا “رهاب العلمانية”، من قبل فئة واسعة من مؤيدي الحكم الجديد، ومعظمهم ربما غير مطلع على أي شيء بخصوص المفهوم أو تاريخه وإنجازات تطبيقه على تقدّم الدول والشعوب وتحقيق حالة استقرار مجتمعي في البلدان المتعددة دينياً ومذهبياً، لكن بالتأكيد، أن قسماً كبيراً من هذه الفئة يعيش حالة رهاب العلمانية، انطلاقاً من دعاية مشغول عليها سياسياً وإعلامياً قامت بالربط بين الدين والتديّن وبين الانتصار على النظام، ووضعت العلمانية كنقيض لحقّ ممارسة البشر لعقائدهم الدينية، كما روّجت إلى أن النظام السابق كان ديكتاتورياً لأنه كان علمانياً، وأن ما يحصل اليوم من تحويل مظاهر التدين من أطرها الخاصة، مثل المساجد، إلى الفضائين العام والمؤسساتي (الشوارع، الجامعات)، كما يظهر من سلوك دوريات للأمن العام تجوب شوارع المدن، رافعة راية التوحيد، مع هتافات دينية، أو إقامة الصلاة العامة في ساحات الجامعات.
أي أنه بالتوازي مع تصعيد حدّة العلمانوفبيا، تجري عملية قولبة للدولة، أو قولبة لشرعية الدولة وأهدافها، وكأن هذف الدولة ونظامها السياسي تحقيق غايات دينية من منظور فئة دينية محددة، وليس تحقيق الأمان والعدل والكرامة، والنهوض بالعلم والبحث العلمي والتكنولوجي، أو تحقيق المواطنة المتساوية، أو الدفع بالحياة السياسية نحو الديمقراطية، وصون حق الأحزاب بالتنافس السياسي السلمي، أو تحقيق استقلال القضاء، وزيادة الناتج القومي، وزيادة دخل الفرد، وإنشاء بنى تحتية تتناسب مع حاجات المجتمع، وفق أرقى المواصفات العلمية والعالمية، أو تحقيق سيادة الدولة على أراضيها، وغير ذلك الكثير من مهام الدولة.
أيضاً، تجري عملية قولبة للمجتمع، وإظهاره بأنه مجتمع قاصر في وعيه ودينه وتدينه وتجربته الحياتية والتاريخية، وأنه بحاجة إلى وصاية عليه من قبل مؤسسات عليا، تقوم بتصحيح سلوكه، وتذكره في كل لحظة بدينه وتعاليمه، وبفضل السلطة عليه لأنها تمنحه حرية ممارسة دينه وشعائره، وبالتالي، فمن حق السلطة عليه، وواجبه، أن يقوم بطاعتها بشكل كامل، بغض النظر عن نجاحاتها أو إخفاقاتها في مجالات التعليم والصحة والخدمات والمعيشة والصناعة والزراعة…. إلخ.
إن ما نشهده اليوم من انتشار للعلمانوفوبيا ليس تعبيراً عن ميل عام جماهيري “إسلامي” كما يجري تصويره، فالناس مرتبطة تاريخياً، وبغض النظر عن التباينات بين المجتمعات، بمصالحها وبمدى قدرة الدولة على تلبية تلك المصالح، لكن هذه الظاهرة، هي احتياج للسلطة الحاكمة، لتبرير وجودها أولاً، والتعتيم على تاريخها، وادعاء تمثيلها الأكثرية، وأنها تتحدث باسمهم، ومحاولة تمكين نفسها في الحكم، والتغطية على عجزها في إحراز تقدّم ملموس في الملفات الأمنية والاقتصادية والعلاقات الخارجية وبناء الجيش وتأمين الخدمات للناس.