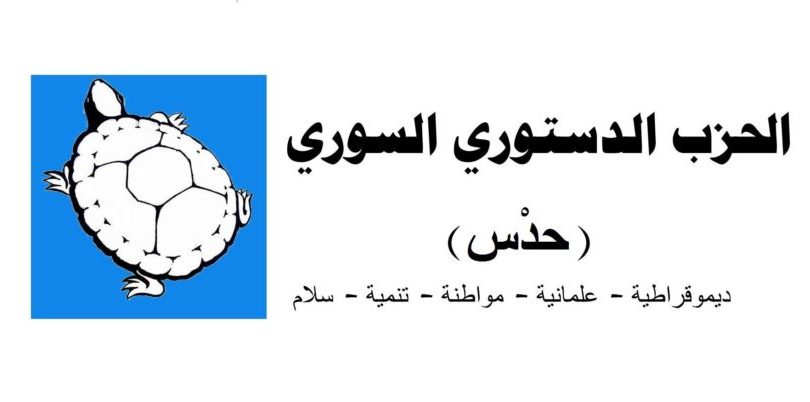في نقد “المقاومة الإسلامية” مفهوماً وواقعاً وخياراتنا المطلوبة
حسام ميرو
نحن معنيون في المشرق العربي بتقديم نقد لما جرى بعد السابع من أكتوبر في غزة، ليس بالوقوف فقط عند الأحداث الأخيرة، بل بكامل المنظومات الموجودة في المشرق، ومن بينها منظومة المقاومة، والتي أصبحت تعرف ب”المقاومة الإسلامية”.
هناك رأيان سادا بعد “طوفان الأقصى”، يحتاجان إلى تفحّص، الأول يقول بأن الخلل في موازين القوى بين تنظيمات المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي لا يعني الكفّ عن المقاومة بوصفها خياراً أساسياً في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأن مقاومة هذا العدو، ينبغي أن تبقى البوصلة والفيصل في المواقف، أي التفريق بين الوطني والقومي والأخلاقي وبين نقيض هذه الصفات.
الرأي الآخر، يقول إن قضية فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ينبغي أن تخضع لشروط موازين القوى، ليس من أجل الاستسلام لهيمنة تفوّق العدو، وإنما لتجنيب أصحاب الحقّ، خصوصاً المدنيين، كارثة إضافية أكبر من سابقاىها، كما جرى ويجري في غزة، التي دفع أبنائها وبناتها ثمناً باهظاً على المستويات البشرية والعمرانية والمعيشية، إذ يقدر عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بأكثر من 41 ألفاً من الفلسطينيين، ناهيك عن عشرات آلاف الجرحى والمعاقين، وتدمير معظم البنى السكنية والخدمية، من طرق ومستشفيات ومدارس وغيرها.
تفحص هذين الرأيين غير ممكن عملياً من دون الإحاطة بواقع الدولة في العراق وسوريا ولبنان، وقد أصبحت الغائب الأكبر، لمصلحة قوى غير نظامية، ممثّلة بالفصائل والميليشيات، وأنظمة سياسية تابعة لمعادلات وقوى خارجية، تلعب فيها إيران وتركيا وإسرائيل الدور الأكبر، مع فارق في بنك أهداف كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة، وأدواتها وطرق عملها.
أيضاً، من غير الممكن تفحّص هذين الرأيين، من دون الوقوف على ظاهرة، جرى العمل عليها منذ عام 1982، وهي تلزيم المقاومة في لبنان لطرف فصائلي محدّد، هو “حزب الله”، أصبح الناطق السياسي الأبرز لطائفة محدّدة (الطائفة الشيعية)، والذي انتقل مع الوقت من مجرّد فصيل عقائدي مسلح إلى تنظيم يشبه الدولة، بهيكليته وموارده وعلاقاته، مانعاً في الوقت نفسه الدولة اللبنانية من أن تكون دولة، ووضع لبنان واللبنانيين أسرى خياراته المنفردة، والتي تفتقد إلى الإجماع الوطني.
كما أنه لا يمكن تفحّص الرأيين السابقين حول مجريات الأحداث ما بعد “طوفان الأقصى”، من دون الإجابة عن سؤال أساسي، وهو : من تخدم تنظيمات المقاومة في واقعها الحالي، هل تخدم فعلاً قضية المقاومة، أم أنها مجرد أذرع لمشروع إمبراطوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ سواءً في رغبتها التوسعية أو كورقة للتفاوض مع أمريكا والغرب؟
إلى جانب هذه الأسئلة، هناك سؤال يتعلّق ببنية تنظيمات المقاومة، التي تتخّذ من الدين والمذهب عقيدة لها، أي أنها تستمد الكثير من شرعيتها من الدين، هذه الشرعية التي لا تتناقض مع الشرعية الدينية لقسم كبير من القوى السياسية الإسرائيلية، وخصوصاً قوى اليمين المتطرّف في دولة الاحتلال، مع فارق جوهري لمصلحة إسرائيل، يتصل بمستوى عقلاني وديمقراطي في إدارة الحياة السياسية، وإدارة الدولة.
شكّلت تنظيمات المقاومة الإسلامية بدائل للدولة في المشرق العربي، وأصبحت مصدر دخل كتلة كبيرة من الأسر، التي تعيش على ريع يأتي من العمل العسكري أو المدني الذي توفّره هذه التنظيمات ومؤسساتها، في الوقت الذي تضاءل فيه حجم الإنتاج الاقتصادي الطبيعي في العراق وسوريا ولبنان، بل أن نهب مقدرات الدولة، أصبح جزءاً من سياسات هذه التنظيمات، خصوصاً في العراق النفطي، ووفق هذه الظاهرة، فإن هذه التنظيمات لا مصلحة فعلية لها في حالة استقرار الدولة الوطنية، التي من مهامها احتكار السلاح، وتأمين سيادة البلاد، وبناء سياسات خارجية على أساس عموم المصلحة الوطنية، والمساعدة في نمو وتنمية دورة إنتاج وطنية.
في هذه الحال، ما الذي يبقى من فكرة المقاومة بشكلها الحالي، الديني، المذهبي، المناقض للدولة الوطنية، ولا تحظى بإجماع وطني في بلدانها؟
إذاً، هل يكفي القول بإن قتال إسرائيل وحده قادر على منح هذه التنظيمات شرعية عملها ووجودها وإلزام الشعوب بالوقوف إلى جانبها؟
وأيضاً، لماذا ينبغي وضع العداوة في المشرق مع إسرائيل في المرتبة الأولى، وتقديمها على العداوة مع المشروعين الإيراني والتركي؟
وبالأحرى، أليست كل هذه القوى، إيران وتركيا وإسرائيل، هي على النقيض مع ضرورة عودة الاستقلالية للدولة الوطنية في المشرق العربي؟
إن التصفيق لمقولة المقاومة من دون تدقيق في جوهر “المقاومة الإسلامية”، ومدى تناقضها مع قيام الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، هو تصفيق غير عقلاني، أي أنه لا يقوم على حسابات نابعة من ضرورات الراهن والمستقبل، ويخدم فعلياً مشاريع لا علاقة لها بإنتاج بنى متقدّمة (غير دينية وطائفية) في المشرق العربي، الذي دخل منذ سنوات في نفق الاستثمار السياسي في الطائفية.
أيضاً، لا ينبغي الاندفاع إلى تبني ما يسمى “خيارات المقاومة” التي تدفع المنطقة وشعوبها إلى الدمار، فهذه الخيارات أسيرة أنظمة استبدادية قائمة، عاشت وتعيش من استمرار منظومات تخدم مصالح نخبها الضيقة، ولا تهتم من قريب أو بعيد بمصالح شعوبها، خصوصاً الفئات المهمّشة والفقيرة، التي تحوّلت إلى وقود في حروب ومعارك وخيارات “التنظيمات المقاومة”.
هل هذا يعني بالضرورة الانحياز إلى دولة الاحتلال في إسرائيل؟
إن نقد واقع ما يسمى “المقاومة” التنظيمي وبناها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، هو انحياز إلى واقع آخر مناقض تماماً لما هو قائم الآن، انحياز إلى التفكير بكيفية العمل الفكري والسياسي والتنظيمي لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، التي تمتلك مقوّمات الدفاع عن نفسها، وعن مواطناتها ومواطنيها وفق حالة إجماع وطني مدروسة، وقائمة على مقاربات لموازين القوى، وتقييم الضرورات والإمكانات.
لا يمكن للبنى الطائفية العابرة للحدود، والتي لا تعترف بالدولة، بل تعتاش على فكرة غيابها، وتتانقض مع فكرة المواطنة، أن تقدّم نموذجاً في مقاومة الأعداء الخارجيين، طالما أنها تقيّم نفسها في مرتبة أعلى من مواطنين آخرين، لا يشاركونها في العقيدة (مهما كانت)، أو في الخيار السياسي، بل تعاملهم بوصفهم أعداءً لها، إذا ما خالفوها في تقييماتها أو خياراتا، وتصنّفهم بناءً على ذلك بأنهم خونة وعملاء للأعداء الخارجيين.