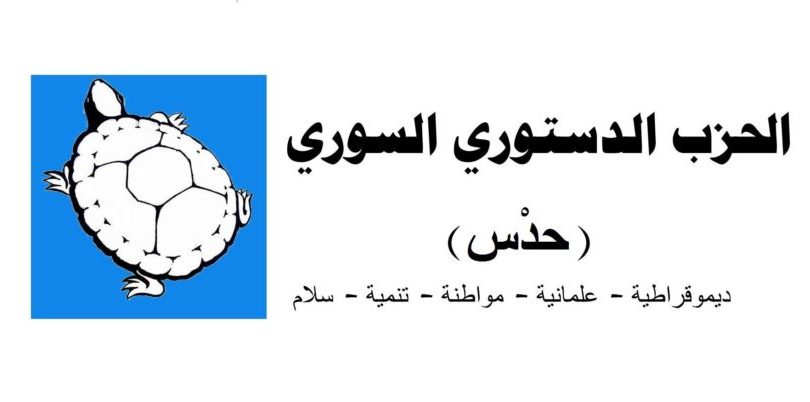أمراض الوسائط: الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني في سوريا

محمد حلاّق الجرف – حدْس
تشهد سوريا منذ 9 سنوات أزمة سياسية كبيرة تكاد تودي بما تبقى من البلد وشعبه بعد أن كان الأمل كبيراً في ثورتها، وفي ظلّ الحاجة إلى “السياسة” كأداة معرفية لتحليل الوضع واستنباط الحلول نجد أنّها -أي السياسة- هي الغائب الأكبر عن أهم حدث سياسي عاشته البلاد منذ نشأتها، وذلك على الرغم من الحضور الشديد لكافة أنواع المحللين على شاشات الفضائيات وفي صفحات التواصل الاجتماعي!.
مع بدء الثورة، وفي ظل التغييب المقصود للدولة من قبل النظام واكتفائه بالوجه الأمني منها، انبثقت كالفطر أحزاب وتيارات “سياسية” للتعبير عن مصالح الناس وتطلعاتهم، وجمعيات ومنظمات “مجتمع مدني” لتأمين بعض احتياجاتهم، فكان شكلا التنظيم الاجتماعي السابقين هما “الوسيط” الذي حاول أن يمتص الهزات العميقة التي تعرّض لها المجتمع السوري.
في ظلّ غياب التشاركية السياسية لمدة تزيد عن 50 عاماً، كان من الطبيعي أن تتخبط النخب التي أخذت على عاتقها مهمة التصدي لإنشاء هذه الأحزاب والمنظمات، لكن الأمر لم يعد مبرّراً اليوم بعد قرابة العقد من التجريب، لذا وجب الآن الوقوف بجدية كبيرة لقراءة المرحلة الماضية بنقد جدي، حتّى لو كان قاسياً.
يجب أن تتركز مهمة هذه “الوسائط” في 3 محاور رئيسة تصلح لأن تكون “مبادئ استاتيكية” على نحو ما يدعوه مناطقة الكلام السياسي، وهذه المحاور هي: النضال ضدّ الاستبداد، والنضال ضدّ أسلمة المجتمع، والحفاظ على سيادة البلد.
وعلى ضوء هذه الاستاتيكا يمكن أن تتحدّد المهام “الديناميكية المرنة” التي يجب أن يتحرك الحزب أو منظمة العمل المدني في محيطها، لكن ما جرى ويجري في سورية هو أنّ المثقفين أخذوا على عاتقهم مهمة إنشاء “الوسائط” وكتابة مبادئها وأوراقها، غير أنّ معظمهم تحول إلى مجرّد سياسي انتهازي يبحث عن مجرّد بقعة ضوء في ظلّ تحالف كبير، أو باحث عن تمويل يُعين به بناء حزبه أو منظمته حتّى لو أدّى ذلك إلى تغيير كل شكل وهيكلة وموضع ذلك الحزب، أو تلك المنظمة.
هذا مرض، مرضٌ آخر يُصيب “الوسائط” هو تذاكي ناشطيها، فتراهم يراهنون على هذه القوة الإقليمية أو تلك، ويسيرون في السياسة حيث تسير، ولذلك ترى تقلباً شديداً في المواقف والآراء بحسب تغيّر المزاج الدولي حول سورية، وعلى الأغلب، يتحوّل هؤلاء الناشطين بسبب هذه الآلية إلى مجرّد ورقة لعب يستخدمها الآخرون لشرعنة ما هو غير شرعي في السياسة.
من الأمراض الشائعة الأخرى، هو افتراض معرفة أن السوريين يريدون هذا ولا يريدون ذاك، أي وهم معرفة المزاج العام دون إجراء دراسات أو استطلاعات رأي، والاستعاضة عن ذلك بقراءة ما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، ولذلك نرى ساعات طويلة تضيع في الجدل بين القوى السياسية، أو حين تشكيل التحالفات، حول قضايا يحسمها البرلمان.
من مهمة الحزب أو التحالف الأساسية، من وجهة نظر محايدة، هي التعبير عن هويته هو، عن رؤيته هو، أما هوية الدولة، أو شكلها، فهي أمور تُترك للتعاقد الاجتماعي أن يحسمها، وهكذا تبقى مهمة الحزب هي النضال لتحقيق رؤيته.
في هذا السياق تعترف معظم الأحزاب السياسية في سوريا أنّ تأثيرها يكاد يكون معدوماً في الحدث السياسي الراهن، وأنّ لا وجود حقيقي لها بين النّاس، ومع ذلك، تراها حريصة على هذه الشعبية وعلى تواجدها بين الناس!، ولذلك وبدلاً من بلورة هوية واضحة ومحدّدة لها ترى قراءاتها وبياناتها وأوراقها عمومية وتلفيقية تحاول أن تُرضي الجميع في نفس الوقت، والمثال الأوضح على ذلك هو قضية العلمانية، فمعظم النشطاء، وأثناء الحوارات التأسيسية تراهم مؤمنون بها، ولكنهم يتهربون منها عند خروج الأوراق إلى العلن بحجة الخوف من انخفاض رصيدهم الذي بالكاد يكون موجوداً.
النقطة الأخيرة التي أود ذكرها، هي غياب مبادرات الحل الجدية، ذلك أنّ أهم ما يطلبه الناس ممن يدعي التصدي لتمثيلهم هو رؤية واضحة وممكنة لخلاصهم. لا تعرف الأحزاب، على اختلافها، شريحتها المستهدفة، ناسها الذين تريد تمثيلهم والدفاع عنهم، لذلك وأثناء حرصها على خطاب الجميع تراها لا تخاطب أحداً!.