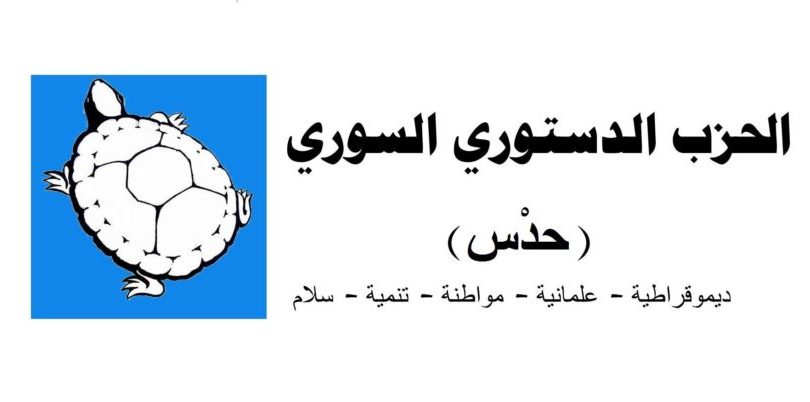لماذا تطوّر الآخرون وتأخّر العرب؟
د. رفعت عامر
قادَ محمد علي باشا عام 1820، عملية إصلاح في بنية الدولة وتحديثٍ للمجتمع في مصر، لم يكتب لها النجاح. وبعدها بقرن كامل، قدّم كل من العلامة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني مساهمات فكرية وثورية في حقلي الثقافة والتنوير الديني، ولم يكتب لها الاستمرار أيضا. وغير تلك المحاولات، عاش العرب عصورا طويلة من الانحطاط في كل حقول الفلسفة والثقافة والاقتصاد، جعلت بلادهم مستباحة للاستعمار بكل أشكاله.
أتت صدمة الاستعمار الحديث للعالم العربي في القرن العشرين، كمرحلة تميزت بهيمنة النظام الرأسمالي على جغرافيا العالم. وكان المنتظر من هذه الصدمة والاحتكاك مع الاستعمارين الفرنسي والبريطاني أن يحدثا تحولاً في بنية المجتمعات العربية، وأن ينقلاها باتجاه العصرنة والتحديث، من نظام الإنتاج ما قبل الرأسمالي (خليط بين الإقطاعية والعبودية المملوكية) إلى النظام الرأسمالي، والدولة الحديثة التي تناسب متطلبات المستعمر الوافد، وحاجاته في التقسيم الدولي للعمل، بين دول متقدمة منتجة، ودول مستوردة للمنتجات الغربية ومصدرة للمواد الأولية.
أحدث الاستعمار الحديث في بلداننا تبدلا في الشكل، ولكن في العمق، بقيت منظومته الليبرالية في الاقتصاد والسياسة والفكر وقيم الشغل والإنتاج والتحديث، من دون أي تغيير يذكر، كالذي حدث في أماكن أخرى من العالم.
انقطع العالم العربي عن صيرورة التطور التاريخي الطبيعي، ولم تمثل عمليات التحديث الرأسمالية الوافدة بديلاً عنها، فخرجت دوله وشعوبه عن سكة القطار إلى أن أتت ثورات الربيع العربي، سعيا لتصحيح مسار التاريخ، ولكن هذه الثورات تعرّضت للانتكاس، بسبب تعشق الاستبدادين السياسي والديني في منظومة استبدادية واحدة، على أرضية قيم مجتمعية تقليدية وثقافة قر وسطية ومناهج فلسفية وتعليمية وفكرية دون العصر واستحقاقاته.
دلّت التجربة التاريخية على أن الخلاص من شجرة الاستبداد لا يتم ببتر ساقها السياسي، وإنما بقلع الشجرة من جذورها. وإن إزالة الاستبداد السياسي شرط جازم لا بد منه، ولكنه غير كافٍ للخلاص من الاستبداد بمنظومته الكاملة في السلطة والمجتمع، وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والتنمية على أنقاضه.
وفي الجواب عن سؤال المقال: لماذا تطور الآخرون وتأخر العرب؟
انه سؤال عام، وتحتاج الإجابة عليه إلى جهود كبيرة ومتكاملة في حقول العلوم الإنسانية كافة. ولكننا سنكتفي هنا بذكر أهم المبادئ التي ارتكزت عليها مناهج الغرب الفلسفية والثقافية والفكرية، والتي كانت مسؤولة عن تقدمه، وكان غيابها هو السبب في تأخر مجتمعاتنا وهيمنة الاستبداد عليها. وأهمها:
1- الطبيعة تحكمها قوانين بسيطة، يمكن اكتشافها وترجمتها إلى معادلات رياضية، يسهل فهمها وإدراكها وتطبيقها والتحكّم فيها.
2- الطبيعة الإنسانية واحدة ويحكمها القانون الطبيعي المادي، وليس للميتافيزيقيا الغيبية من وجود وحضور إلا في غياب العقلانية والمنطق ،وغياب الإيمان بقدرة الإنسان على اكتشاف قوانين الطبيعة.
3- العقل الإنساني صفحة بيضاء تتراكم فيها المعطيات الحسية والأفكار البسيطة، لتصبح أفكاراً مركبة وثوابت ومطلقات.
4- الإنسان ابن بيئته والشروط المادية والاجتماعية التي يعيش فيها.
5- العقل الإنساني قادر على بلوغ الحقيقة المطلقة، وإدراك قوانين الطبيعة وفهمها، من دون الحاجة إلى وسيط، ويمتلك القدرة على حل جميع مشاكل الإنسان وتحقيق التقدم اللامتناهي.
6- المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة والخبرة الحسية والتجريد الرياضي.
7- الحقيقة نسبية على الدوام، ومطلقة فقط في اللحظة التي ما زلنا دون اكتشاف ماهية الظاهرة وقانونها. وبعد اكتشافها تعود الحقيقة إلى نسبتيها.
هذه هي أهم المبادئ والمرتكزات التي قامت عليها الفلسفة والمناهج الغربية، والتي تفسر سبب تقدمه العلمي والتكنولوجي والمعرفي، الذي أحدث تغييراً جذرياً في حياة الناس وأفكارهم ومعتقداتهم وعلاقتهم مع أنفسهم، ومع الطبيعة والوجود. وغيابها عن الفلسفة والمناهج العربية يفسر جزئياً سبب التأخر المتراكم، والاستعصاء في عمليات التحول والإصلاح والخلاص من الاستبداد، الذي يُعيد إنتاج القيم والمناهج المتخلفة ذاتها.
لقد أنجبت الحداثة الغربية عقلانية مادية، وأسست للثورة العلمية التكنولوجية، وما زالت تتطور وتبني نماذج جديدة في عصر ما بعد الحداثة. بينما العرب ما زالوا غارقين في ثقافة ومعتقدات السلف، ميتافيزيقيا غيبية لا وجود للإنسان الحرّ الفاعل فيها.
لقد بينت احداث الربيع العربي مؤخراً ان قلع شجرة الاستبداد ليس كافياً للتقدم، من دون اقتلاع هذه الشجرة من جذورها الممتدة في أعماق الثقافة والفكر العربي الماضوي.